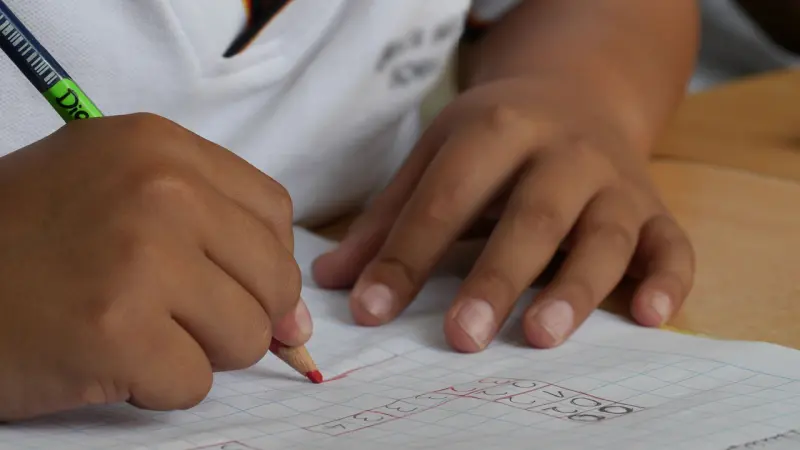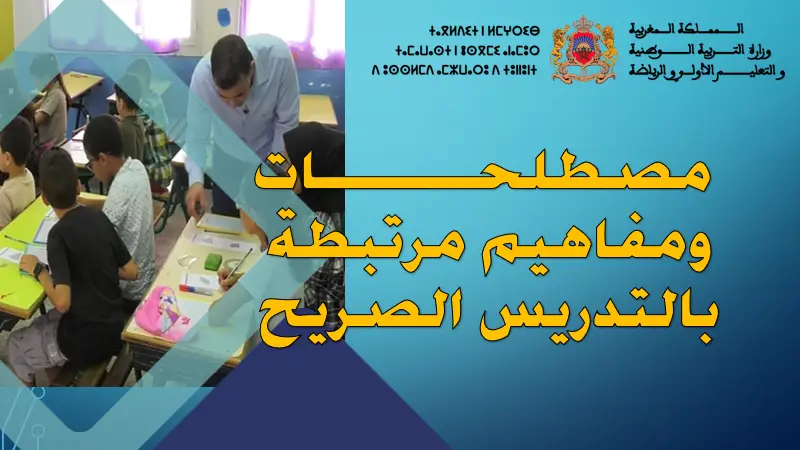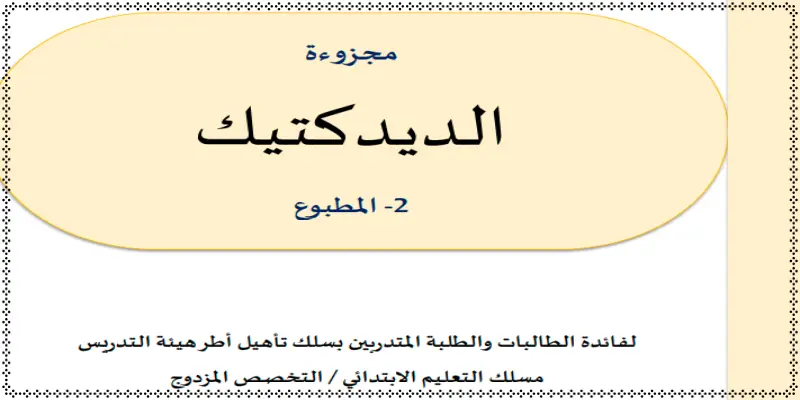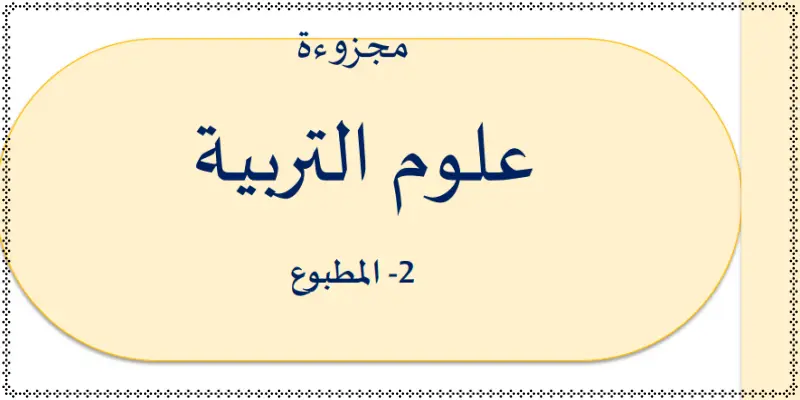تقديم
إن عوائق التعلم ليست مجرد تحديات عابرة، بل هي نقاط تحتاج إلى تشخيص دقيق. لأن فهمها بدقة هو السبيل لبلورة برامج وحلول ناجعة، تركز على تنمية المهارات الشخصية لدى المتعلم وتوفير بيئة محفزة تساعده على تجاوز هذه العوائق.
المدلول اللغوي للعائق
في اللغة العربية، كلمة عائق من يعوق عوقا أو يعيق عيقا، وعاقه الشيء يعني منعه منه وشغله عنه1، إذن فالعائق هو المانع أو الشاغل.
في اللغة الفرنسية: العائق obstacle اسم مذكر استعمل منذ 1220م، جاء من الكلمة اللاتينية obstaclum عن كلمة obstare التي تعني الوقوف أمام الشيء.
والعائق هو كل ما يعترض المرور ويضايق الحركة، وتستعمل كلمة عائق في مجال الاختصاص، للتعبير عن الحواجز أو الموانع المادية التي تشكل صعوبات.
كما تعبّر هذه الكلمة مجازيا عن كل ما يحول دون الحصول على نتائج إيجابية ويمنع من تحقيق الإنجازات، فهو بذلك نوع من المضايقة أو الاعتراض أو الصعوبات.2
المدلول الديداكتيكي للعائق
يتميز العائق بتعدد الوظائف الذهنية، فهو يستعمل للتعبير عن الخطأ، أو الجهل، أو الصعوبات، وكذلك المنع النفسي، أو التمثلات… والواضح أن كل هذه المصطلحات لا تزيد مفهوم العائق إلا تنوعا في خصائصه، سنقتصر على ذكر بعضها فيما يلي:
ماذا يعوق العائق؟
العائق عائق للمعرفة، لكن ليست أية معرفة، فهو يعوق تكوين المعرفة الموضوعية.
إيجابية العائق
يتميز العائق عن الجهل بكونه معرفة أو مجموع المعارف التي تشكل ذاتها العائق.
غموض العائق
يظهر جليا، في إطار المقاربات التي تشتغل على التمثلات، أن البعض منها يرى في التمثلات عوائقا وأيضا أدوات مساعدة؛ لإحداث التغيير المفاهيمي المرغوب فيه.
عمق العائق
على العكس ما يفهم من مصطلح العائق، فهو ليس المانع، أو الحاجز الذي يصطدم به الفكر، فالعائق يوجد ضمن فعل المعرفة ذاتها (المصطلحات، طرائق الاستدلال، الأخبار، التجارب اليومية، اللاشعور…) كل هذه الظواهر تميز الخطأ أي العائق، الخارج عن فعل المعرفة، عن ظواهر أخرى كالسهو أو اللامبالاة، أو عدم التركيز…
الخاصية المتعددة الشكل للعائق
تقتضي عملية تحليل العائق الرجوع إلى أسناد نظرية يمكن تحديد مداها في ثلاثة أبعاد: النفسي والاجتماعي والمعرفي، وفي هذه الأبعاد ومنها يتكون الهيكل العام للعائق، ومنها تتشكل الطبيعة الثلاثية للعائق، وبالتالي فإن كل تغيير يحدث في تمثلات الفرد (فيما أفكر؟ وكيف ذلك؟)، ينتج عنه تغيير في عمليات التحديد (ما قيمتي بالنسبة للآخرين؟)، وعلى هذا الأساس تجري عملية إعادة تقبل الأفكار المتلقية (ماذا أصدق؟).
أنماط العوائق
يميز بروسو Brosso 1986 بين ثلاثة أنماط من العوائق:
العوائق ذات الأصل الأنطوجينيكي Ontogénique
تنشأ عن الحدود الفكرية التي تطبع المتعلم في لحظة ما من لحظات نموه المعرفي.
العوائق ذات المنشأ الديداكتيكي
والتي تنجم عن المحتويات والطرائق التعليمة التي قد تساهم في تشكيل بعض المعارف والمفاهيم المنطوية على أخطاء أو انزلاقات معرفية.
العوائق ذات الأصل الابستمولوجي
وهي العوائق التي تبرز لدى الذات الإبستيمية épistémique والتي لا تعد بأي من الأحوال غريبة عن عمليات وسيرورات البناء المعرفي. لا يتعلق الأمر بعوائق خارجية، كتعقد الظواهر، وسرعة زوالها، ولا بالطعن في الحواس لضعفها أو في الفكر الإنساني: فهي عوائق عبارة عن تعطلات واضطرابات تظهر في فعل المعرفة ذاته وتبرز بكيفية صميمية وبنوع من الضرورة الوظيفية.
أنواع العوائق الابستمولوجية
تنقسم العوائق الابستمولوجية إلى عدة أنواع، ومن أبرزها:
- عائق التجربة الأولى: Obstacle de l’expérience première.
- عائق المعرفة العامة أو عائق التعميم: Obstacle de généralisation ou connaissance générale.
- العائق اللغوي أو اللفظي: L’obstacle linguistique.
- العائق الجوهري أو عائق المادة: L’obstacle substantialiste ou substantialisme.
- العائق الإحيائي أو الإحيائية: L’obstacle animiste ou animisme.
التمثل كعائق
يشكل تمثل ما عائقا:
- بالنسبة لاكتساب مستوى معرفي علمي معين؛
- بالنسبة لصياغة أو حل مشكل معين؛
- في وضعية خاصة؛
- بالنسبة لشبكة تحليل؛
- في حالات نفسية: كالتردد أو المقاومة أو إعادة نفس الخطأ؛
- في حالات ابستمولوجية: حين يكون الخطأ نقطة هامة في بناء المعرفة، وله ما يشابهه في تاريخ العلوم؛
- ظهور علاقة التناقض بين تمثل متقادم وآخر يراد التوصل إليه (جديد)، وفي الوضعيات الديداكتيكية يتم تفكيك بنية القديم من أجل تشييد ما هو جديد؛
- إبداء التمثل العائق صعوبة في عملية تفكيك بنيته، وذلك بمقاومته للتناقضات مع المضامين التي تعرضها وضعيات التمدرس.
مفهوم الهدف العائق
يدل مفهوم الهدف العائق الذي اقترحه Jean louis Martinand (86-1984) على دمج مصطلحين: هدف ثم عائق، والمعلوم أن لكل منهما تاريخ ومرجعية نظرية خاصة به.
فإذا برز الأول كنتيجة لأعمال تطرقت للأهداف البيداغوجية، وعملية إجرائية مضامين التعلم، فإن الثاني جاء كنتيجة لأفكار انصب اهتمامها على الصعوبات التي يواجهها المتعلم في سيرورة اكتسابه للمعرفة.
نذكر ببعض المعطيات الخاصة بكلا المصطلحين:
الهدف التربوي
يشير الهدف التربوي إلى مجموع التغيرات المراد إحداثها أو تنميتها أو تقويمها في سلوك الفرد، على مستوى العقلي أو الحسي-حركي أو الوجداني، وذلك على المدى القريب أو المتوسط أو البعيد.
الهدف العائق
لقد بدا واضحا مما سبق بأن إحراز التقدم الفكري رهين بإحداث القطائع مع المعارف القديمة، واستبدالها بأخرى أعلى درجة، وأرقى مستوى، أما التقدم الثقافي الذي يمكن إحرازه على الصعيد الديداكتيكي، يكمن أساسا في تجاوز عوائق ذات بعد ابستمولوجي أو سيكولوجي أو منهجي.
إذا كانت العوائق تتسم بعمق مغزاها، فإنها أول ما يجب أن تتمحور حولها عملية تحديد الأهداف، وهذا ما يؤكد عليه Martinand بقوله: “تتخذ العوائق في تعليم العلوم معنى ابستمولوجيا عميقا، لكونها في اعتقادي، تجسد المفتاح الرئيس في صياغة الأهداف، والتعبير عنها بواسطة عوائق قابلة للتجاوز من طرف المتعلم، وصفا للأهداف والأنشطة القابلة للإنجاز، قصد توجيه التدخلات البيداغوجية وكذا التقويم المصاحب لها”.
نستنتج من خلال المعطيات السابقة أن اقتراح مفهوم الهدف بتوظيفه للعوائق القابلة للتجاوز كنمط من أنماط اختيار الأهداف المناسبة نتج عنه:
- تحول اتجاه مفهوم الهدف المتمركز حول تحليل المادة الدراسية؛
- إعطاء دفعة جديدة لمفهوم العائق بدل اعتباره كمانع للتعلم.
من الأهداف العوائق إلى وضعيات التعلم
حتى لا يبقى مفهوم الهدف العائق حبرا على ورق، اقترح Martinand نموذجا لإجرائه نلخصه في الخطوات التالية:
- تحديد تمثل تكون نسبة تردده مرتفعة لدى المتعلمين.
- تحديد العائق اعتمادا على شبكة من شبكات تحليل التمثلات (مصادر التمثلات) أو قياس الفارق بين التمثل والمعرفة العلمية.
- اختيار أهداف المضمون المراد تعلمها انطلاقا من شبكة مفاهيمية (تحليل المادة) أو اعتماده صنافة من صنافات الأهداف (يمكن البدء بهذه الخطوة).
- تحديد الهدف العائق، وترمز صياغته إلى المستوى الفكري المستهدف.
- يتطلب الهدف العائق تقويما لشدة “القفزة المفاهيمية” التي سيحققها المتعلم من طرف المدرس، لا بالسهل جدا فتنعدم بوادر العائق، ولا بالصعب جدا فيستحيل على المتعلم تجاوزه، وهي إشارة أكد عليها Vygotski قائلا: “ينحصر العمل الديداكتيكي في تحقيق سبق للأحداث، دون تجاوز نضج البنيات العقلية للمتعلم.”
خاتمة
في الختام، يمكن القول أن الأخطاء التي يرتكبها المتعلم غالبا ما تكون مؤشرا لوجود عوائق. لذا، يبرز هنا دور المدرس في فهم مصدر هذه العوائق والعمل على معالجتها؛ لتقديم معرفة تتناسب مع النمو العقلي والمعرفي لكل فرد. وذلك يتحقق من خلال تهيئة وضعيات تعليمية تعلمية تضمن تحقيق الأهداف المنشودة.