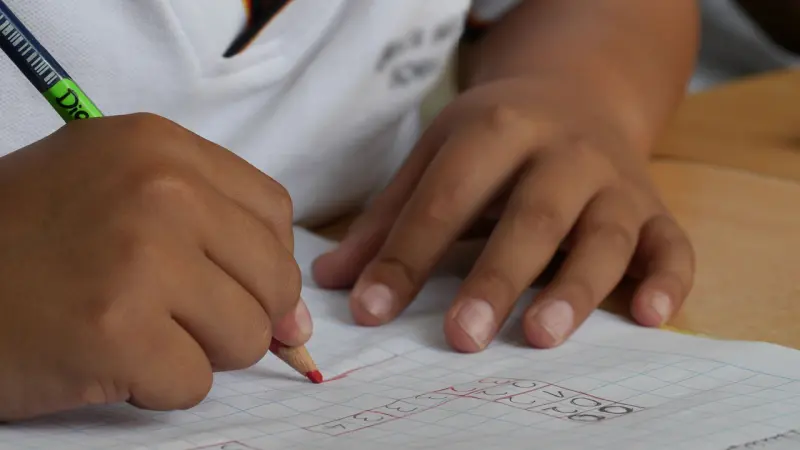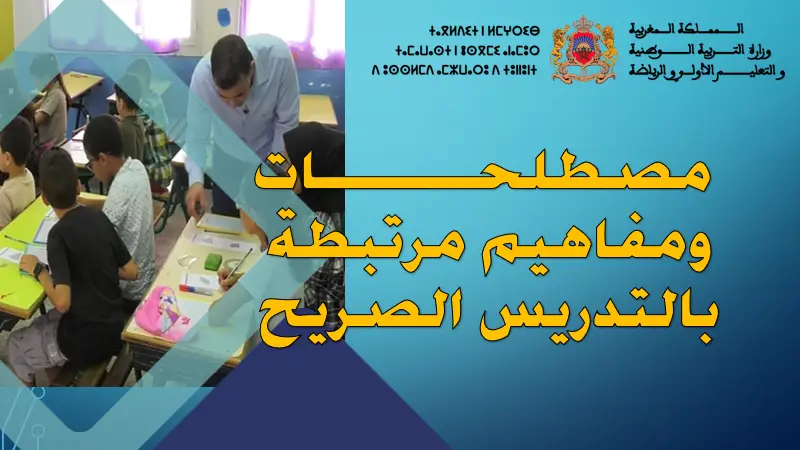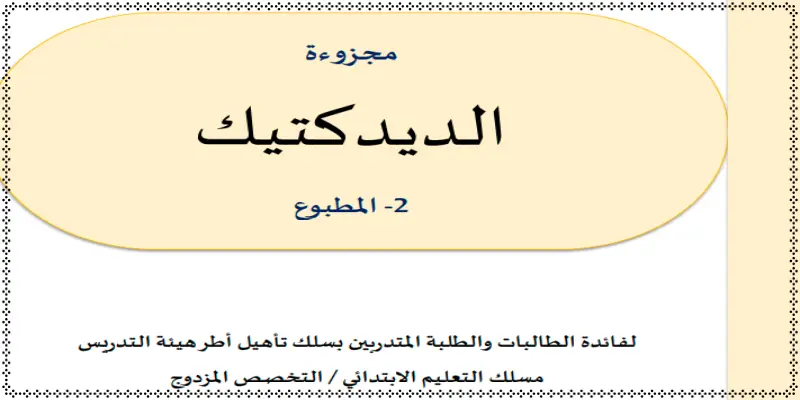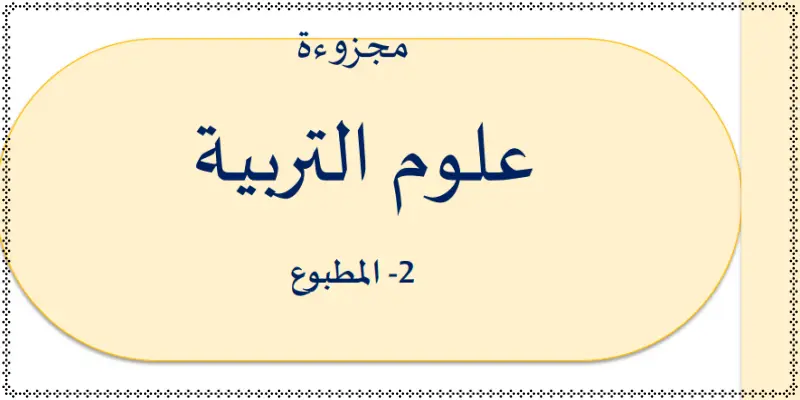یمثل مجال التربیة والتكوین رھانا كبیرا في مسیرة تنمیة بلادنا؛ ومن ھذا المنطلق، كان لزاما التفكیر بعمق في إصلاح منظومة التربیة والتكوین، حیث تشكلت منذ سنة الاستقلال لجان ومجالس خاصة للتربیة والتكوین بھدف إصلاح المدرسة المغربیة، وتوجت أعمالھا بتبني مجموعة من المشاريع والاستراتيجيات، ونخص بالذكر هنا الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030.
وسنحاول أن نعطي تعريفا لكل مفهوم من المفاهيم المتعلقة بهذه الرؤية الاستراتيجية للإصلاح كما عَرَّفَها المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي.
المدرسة
تحيل المدرسة في سياق هذه الرؤية الاستراتيجية، على مجموع مكونات منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي: التعليم الأولي والابتدائي والاعدادي والثانوي؛ التعليم العالي والجامعي والبحث العلمي؛ تكوين الاطر؛ التكوين المهني؛ التعليم العتيق.
الإنصاف
يعني الإنصاف في المجال التربوي:
- الولوج المعمم للتربية، عبر توفير مقعد بيداغوجي للجميع بنفس مواصفات الجودة والنجاعة، دون تمييز قائم على الانتماء الجغرافي أو الاجتماعي، أو النوع أو الإعاقة أو اللون أو اللغة أو المعتقد؛
- توافر كافة البنيات والفضاءات وشروط التأطير التربوي، اللازمة لحاجات التعميم، ولحق الجميع في التربية والتكوين، الكفيلة بإحراز النجاح على أساس الاستحقاق، والاحتفاظ لأطول مدى بالمتعلم داخل المدرسة، واستكمال مسارات التعليم والتعلم بحسب القدرات والمؤهلات؛
- تأمين جميع أنواع الدعم، المادي والتربوي والنفسي والاجتماعي، لفائدة المتعلمين والمتعلمات المحتاجين لذلك، ضمانا للاستفادة المتكافئة من خدمات التربية والتكوين؛
- ضمان الحق في التعلم مدى الحياة للجميع؛
- التتويج بإشهاد في مختلف مكونات المنظومة ومستويات التكوين والتأهيل.
الجودة
يقصد بالجودة في التربية، تمكين المتعلم من تحقيق كامل إمكاناته عبر أفضل تملك للكفايات المعرفية والتواصلية والعملية والعاطفية والوجدانية والإبداعية. وهي تعتمد على:
- التكوين الأساس الرفيع، والتكوين المستمر الفعال والمستديم للفاعلين التربويين؛
- التقويم الدقيق للأداء البيداغوجي والتحفيز على أساس الاستحقاق؛
- مرونة مكونات وأطوار المدرسة وتناسقها وتكاملها؛
- ملاءمة المضامين مع انفتاح النموذج البيداغوجي للمدرسة، ونجاعة البرامج والتكوينات والوسائل البيداغوجية الناجعة وجاذبية الفضاءات والبنيات المدرسية والملائمة؛
- انتظام التقييمات المؤسساتية للمناهج والبرامج والتكوينات، ومراجعتها؛
- تعزيز مكانة البحث العلمي والتقني، والبحث من أجل الابتكار؛
- تطوير نظام الحكامة، على مستوى التدبير، أو التمويل، أو المشاركة، والشفافية، وربط المسؤولية بالمحاسبة.
الارتقاء
يقصد بالارتقاء عمليات تطوير منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، من خلال تجاوز الاختلالات القائمة، وتأهيل البنيات والآليات المعتمدة، وإدراج المستجدات وفق منظور استشرافي. علما أن ذلك لا يتحقق إلا في تفاعل وتكامل مع باقي المكونات والقطاعات المجتمعية الأخرى (الاقتصاد، الإدارة، القضاء، الإعلام والثقافة، الحياة السياسية، إلخ).
يشمل الارتقاء بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي الرفع من مستوى أداء بنياتها وقدراتها، بالنظر للغايات والإنتظارات المجتمعية، سواء تعلق الأمر بالقدرات البشرية، أو المادية (البنيات المادية والتجهيزات والوسائل والموارد)، أو المؤسساتية (الحكامة وبنيات وأساليب القيادة والتدبير والتقييم، المرجعيات التنظيمية والتشريعية، الموارد المالية).
من ناحية ثانية، ينسحب الارتقاء على مستويين متكاملين: الأول يهم الفرد، على أساس قاعدة الإنصاف وتكافؤ الفرص، وجودة التكوين واستدامته بشكل ييسر اندماجه الاقتصادي والثقافي والقيمي، في تلاؤم مع حاجات البلاد ومهن المستقبل. والثاني يخص الارتقاء المجتمعي، من منطلق النهوض بالتنمية البشرية ودور المواطن المؤهل في تنمية الممارسات الديمقراطية، وتحقيق المواطنة المسؤولة، وتطوير البنيات الاقتصادية والإنتاجية وبنيات البحث والابتكار.
المقاربة البيداغوجية
المقاربة البيداغوجية هي الإطار المرجعي الناظم لممارسات التدريس وأنشطة التعلم والتقويم، – وفق غايات وأهداف محددة -، مجموع التوجيهات المؤطرة لأهداف التدريس والتعلم والتقويم، على خيارات مقاربات بيداغوجية تشكل الخيار التربوي المؤسساتي تربوية مؤسساتية لتنفيذ وأجرأة المناهج والبرامج التعليمية والتكوينات.
تحيل المقاربات البيداغوجية بتعددها وتنوعها على خيارات عديدة موجهة: البيداغوجيا بواسطة الأهداف، البيداغوجيا بالكفايات، بيداغوجيا الإدماج، البيداغوجيا التواصلية، البيداغوجيا القائمة على المقاربة المؤسساتية وغيرها، إلى جانب أنواع أخرى من المقاربات البيداغوجية التي تندرج في إطار معاجلة الوضعيات والمواقف التعليمية – التعلمية حسب نوعها وخصوصيتها، على غرار البيداغوجيا الفارقية، بيداغوجيا المشروع، بيداغوجيا الخطأ، بيداغوجيا حل المشكلات…
التناوب اللغوي
خيار تربوي وآلية بيداغوجية يستثمر في التعليم المزدوج أو المتعدد اللغات، يروم تنويع لغات التدريس، وتحسين التحصيل الدراسي فيها.عن طريق التدريس بها؛ وذلك، بتعليم بعض المضامين أو المجزوؤات في بعض المواد باللغة الأجنبية.
التهيئة اللغوية
يُقصد بالتهيئة اللغوية مجموع السياسات العمومية المتعلقة بلغة أو لغات معينة متكلَّمَة داخل مجال سيادتها الوطنية، وذلك من خلال مأسسة الواقع اللغوي، بتحديد الوضع المجتمعي للغة أو اللغات الرسمية، ومكانتها الثقافية ذات الصلة بالهوية الاجتماعية والاستعمال والتداول.
على المستوى الاجتماعي، التهيئة اللغوية تمرين علمي يهدف إلى التغيير الإرادي للغة من خلال التدخل على مستوى متنها (هيكلها)، وذلك من أجل الاستجابة لحاجات المتكلمين بها، و/ أو على مستوى وضعها الاجتماعي – السياسي من أجل ملاءمته مع تطلعات هؤلاء المتكلمين. هذا التدخل يتم على أساس تقييم وضعية اللغة، وتمظهر السياسة اللغوية، والتخطيط اللغوي وتفعيل العمليات.
من الناحية الإجرائية، ترتكز مختلف عمليات التهيئة اللغوية في الجهود التي تدخل ضمن عمليات معيرة النسق اللغوي من حيث جوانبه الشكلية، أو المعجمية والدلالية، أو الرتكيبية، أو التداولية، إلخ، في مواكبة للتحولات التي تعرفها حقول المعرفة والفكر والثقافة والتقنيات.
وعلى المستوى التربوي، تحدد التهيئة اللغوية وضع اللغات داخل منظومة التربية والتكوين، من خلال تخطيط لغوي مندمج يراعي الغايات التي يحددها المشروع المجتمعي للتربية والتكوين، ومتطلبات الارتقاء الفردي والمجتمعي، والعمل على تحديث طرق تعلمها واكتساب كفاياتها، وتيسير استعمالها داخل المدرسة وخارجها.
التكنولوجيات التربوية
يطلق مصطلح التكنولوجيات التربوية على تقنيات المعلومات والاتصال التي دخلت مجال التربية والتكوين، على مستوى التأطير والتعلمات والتكوينات، أو التخطيط والتنظيم والتدبير والتقييم.
تشمل التكنولوجيات التربوية مجموع البرامج المعلوماتية والتفاعلية، والموارد الرقمية، والأدوات التكنولوجية والأجهزة الإلكرتونية المختلفة؛ علاوة على شبكات وأنظمة الاتصال وما توفره من خدمات وتطبيقات (من قبيل التبادل الآني للمعلومات والأفكار، والمؤتمرات عن طريق الفيديو، والتعلم عن بعد، والمكتبات الرقمية، إلخ).
تتمحور أهداف استثمار التكنولوجيات التربوية يف الرفع من جودة التربية والتكوين، على مستويات عدة، أهمها:
تيسير إدراك المعارف المختلفة، وجعل العملية التعليمية التعلمية أكثر جاذبية وإثارة وتشويقا، وتأهيل العنصر البشري للاندماج في مجتمع المعرفة، والتمكين من اعتماد استراتيجيات التعلم الذاتي، وبناء المشاريع الشخصية في البحث والابتكار، وعقلنة الحكامة التربوية باعتماد نظم معلوماتية مندجمة ومتكاملة، وخلق جماعات افتراضية معرفية لتبادل الرأي، وتقاسم الأفكار، وبناء الذكاء الجماعي، ودعم العمل الجماعي بين الفعاليات التربوية، ورفع العزلة عن المدرسين والمؤطرين والباحثين في التربية والتكوين.
المهننة
تدل المهننة على مجموع العمليات التي تستهدف تحويل نشاط ما إلى مهنة اجتماعية منظمة، يحركها إنتاج موضوعات أو خدمات معينة، ولها إطارها التنظيمي والاجتماعي، وقواعدها ومتطلباتها الخاصة بالأداء المهني.
في مجال التربية والتكوين، ترتبط المهننة بالتكوين، المعرفي والتربوي والعملي الدائم، الذي يستغرق المسار المهني بأكمله، بهدف إكساب الكفايات اللازمة لممارسة المهام التي تتطلبها المهن التربوية (التدريس والتكوين والتأطير والتدبير والتوجيه)، بغاية الارتقاء بجودة الأداء المهني ومردوديته. وهو أداء يقتضي المرونة الكافية لقيادة مختلف الوضعيات الخاصة بكل مهنة، والقدرة على التوظيف الناجع لمختلف الموارد المتاحة، وملاءمتها لهذه الوضعيات، قصد تحقيق الأهداف المتوخاة من العملية التربوية في شموليتها، وفي مقدمتها إنجاح التعلمات.
التكوين بالتناوب
نمط تربوي وتعليمي يتم المزاوجة فيه على الأقل بين مكانين من التكوين: أحدهما تكوين تطبيقي يتم في وضع إنتاجي من وسط صناعي أو مهني أو تجاري، وآخر يتم في مؤسسة (الجامعة، مدرسة تقنية عليا أو التكوين المهني) يقوم بتوسيع المعارف المكتسبة والكفايات المتعلمة (مؤسسة التكوين والمقاولة).
ومن أبرز تجليات التكوين بالتناوب في نظام التكوين المهني بالمغرب نجد نمطي التمرس المهني والتدرج المهني.
التدرج المهني
يعتبر التكوين بالتدرج المهني نمطا من أنماط التكوين المهني، وهو منظم بموجب القانون 12.00، ويرتكز على تكوين تطبيقي يتم بالمقاولة بنسبة 80 % على الأقل من مدته الإجمالية، ويتم بنسبة 10 % على الأقل، من هاته المدة، عبر تكوين تكميلي عام وتكنولوجي منظم بمراكز التدرج المهني.
يستهدف هذا النمط من التكوين بالأساس، الشباب الذين لا يتوفرون بالضرورة على الشروط المطلوبة لولوج التكوين المهني (المستوى الدراسي والسن)، وذلك بهدف تمكينهم من الحصول على التأهيل الضروري لممارسة نشاط مهني.
تخضع علاقة التكوين بالتدرج المهني لعقد يبرم بين المتدرج أو ولي أمره والمقاولة، ويتولى تأطير المتدرج داخل المقاولة مؤطر مهني يتم تعيينه لهذا الغرض.
التمرس المهني
يعتبر التمرس المهني نمطا من أنماط التكوين المهني بالتناوب، أحدث بموجب القانون رقم 36.96، ويرمي إلى ربط التكوين بالوسط المهني بحكم أنه يتم في فضاءين مختلفين ومتكاملين (مؤسسة التكوين-المقاولة)، حيث يتم بنسبة النصف على الأقل من مدته الإجمالية داخل المقاولة، وبنسبة الثلث على الأقل من هذه المدة بمؤسسة التكوين المهني.
تخضع علاقة التمرس لعقد يبرم بين صاحب المقاولة والمتمرس. ويؤطر المتمرس داخل المقاولة مكون مصاحب تعينه هذه الأخيرة. ويكون المتمرس مؤمنا من طرف مؤسسة التكوين المسجل بها، حيث يحتفظ بصفة متدرب.
التكوين التأهيلي
يندرج هذا التكوين في إطار تحسين قابلية التشغيل لدى الشباب حاملي الشهادات والباحثين عن الشغل بشكل عام.
يُمكِّن التكوين التأهيلي المستفيدين منه من الحصول على تأهيل عملي لممارسة نشاط مهني وفق الشروط التي يتطلبها هذا النشاط.
تتراوح مدة التكوين به ما بين 3 و9 أشهر، تتخللها تداريب داخل المقاولة.
التعليم العتيق
نوع من التعليم المتوارث تاريخيا بالمغرب، اهتم به المجتمع ووفر له شروط الاستمرار، من خلال بناء المدارس ومراكز الدراسة، وتهيئ الدور لإيواء الطلبة.
يمارس التعليم العتيق مهامه في إطار القانون رقم 13.01 الصادر في تنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.09، بتاريخ 15 ذي القعدة (29 يناير 2002).
يهدف التعليم العتيق حاليا إلى تمكين التلاميذ والتلميذات والطلبة المستفيدين منه من إتقان حفظ القرآن، واكتساب العلوم الشرعية، والإلمام بمبادئ العلوم الحديثة، وتنمية معلوماتهم ومعارفهم في مجال الثقافة الإسلامية، وضمان تفتحهم على اللغات الأجنبية، والعلوم والثقافات الأخرى في ظل مبادئ وقيم الإسلام.
يلقن التعليم العتيق بالكتاتيب القرآنية والمدارس العتيقة وبمؤسسات التعليم النهائي العتيق، بما فيها جامع القرويين والجوامع الأخرى وفق الأنماط العتيقة، مع مراعاة القوانين والأنظمة المعمول بها في ميدان التربية والتكوين، وطبقا لأحكام القانون المنظم للتعليم العتيق.
تشمل الدراسة بالتعليم العتيق الأطوار التالية: التعليم الأولي العتيق؛ التعليم الابتدائي العتيق؛ التعليم الإعدادي العتيق؛ التعليم الثانوي العتيق؛ التعليم النهائي العتيق.
تشرف على التعليم العتيق وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، مقابل التعليم الأصيل الذي تشرف عليه وزارة التربية الوطنية.
مجتمع المعرفة
المجتمع الذي يقوم أساسا على المعرفة، باعتبارها محركا قويا للتحولات الاقتصادية والاجتماعية، ومقوما من مقومات تنافسية الدول، ونشرها وإنتاجها، وتوظيفها بكفاءة في جميع مجالات النشاط المجتمعي: الاقتصاد والمجتمع المدني والسياسة، والحياة الخاصة، وصولا للارتقاء بالحالة الإنسانية باطراد، أي إقامة التنمية الإنسانية.
يعتبر مجتمع المعرفة أكبر استثمار في تاريخ المجتمعات في القدرات المعرفية والتواصلية للأفراد والمؤسسات، إلى جانب القدرات والبنيات المادية للتربية والتكوين، بشكل يقوي فرص الأفراد في تنمية شخصيتهم وإمكاناتهم وارتقائهم الاجتماعي، لا سيما تضييق مساحات اللامساواة والإقصاء والتهميش والهشاشة الاجتماعية. كما يقوي التنافسية العامة للمجتمع ومؤسساته في مجالات المعرفة والاقتصاد والتأهيل البشري في جميع المجالات المعرفية بما في ذلك العلمية والفنية والثقافية والتراثية والخبرات المجتمعية المتراكمة.
يرتبط ولوج مجتمع المعرفة أيضا بتوسيع وتكثيف إمكانات استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال، وتنامي وتنوع طرق التعلم مدى الحياة، والانفتاح على لغات مجتمعات العالم وثقافاته، والتعويل على البحث العلمي والابتكار، وتكسير الحواجز بين الأفراد والجماعات والشعوب، وتشجيع وتنمية النبوغ والتفوق الدراسي والتكويني.
السلوك المدني
“إن الغاية المثلى من تنمية السلوك المدني هي تكوين المواطن المتشبث بالثوابت الدينية والوطنية لبلاده، في احترام تام لرموزها وقيمها الحضارية المنفتحة، المتمسك بهويته بشتى روافدها، المعتز بانتمائه لأمته، المدرك لواجباته وحقوقه.
كما تستهدف تربيته على التحلي بفضيلة الاجتهاد المثمر، وتعريفه بالتزاماته الوطنية، وبمسؤولياته اتجاه نفسه وأسرته ومجتمعه، وعلى التشبع بقيم التسامح والتضامن والتعايش ليساهم في الحياة الديمقراطية لوطنه، بثقة وتفاؤل، في اعتماد على الذات وتشبع بروح المبادرة.
وتندرج هذه الأهداف النبيلة في إطار خيارنا الثابت لترسيخ مغرب المواطنة المسؤولة والديمقراطية والتضامن، وتكريس دولة الحق والقانون، في انفتاح على القيم الكونية.
وهو نفس الخيار الذي اعتمدنا في إطلاق مختلف الأوراش الكبرى ببلادنا، سواء في مجال النهوض بحقوق الإنسان ودمقرطة المجتمع، أو في هيكلة الحقل الديني، وإصلاح المنظومة التربوية، وتحديث قطاع الاتصال، فضلا عن تخليق الحياة العامة، والنهوض بقضايا الأسرة والطفولة.
وكل ذلك مع الحرص على إجراء قطيعة لمختلف الممارسات اللامدنية، ولكل مظاهر التعصب والتطرف والانغلاق، مهما كانت مرجعيتها المذهبية، ودوافعها الاجتماعية، سواء أكان ذلك في بلادنا أو خارجها.”
مقتطف من نص الرسالة الملكية الموجهة إلى أعمال الندوة الوطنية التي نظمها المجلس الأعلى للتعليم حول: “المدرسة والسلوك المدني”.
الرأسمال البشري
الرأسمال البشري أحد مكونات الرأسمال غير المادي لكل بلد. ويقصد به مجموع الكفاءات والقدرات البشرية، في مجالات المعارف الأكاديمية والمنهجية والتكنولوجية، والكفايات الثقافية والقيمية، والمهارات العملية، التي يتوفر عليها سكان بلد معين، والتي تؤهلهم للإسهام الفاعل في تنميته، والارتقاء بقدراته الإنتاجية والمؤسساتية، وثروته الاقتصادية، بشكل يحقق رفاه العيش بالنسبة لكل فرد.
يشكل الرأسمال البشري الثروة الحقيقية لكل بلد، لأنه إمكان غير مادي، قابل للاستمرار والتجدد والتطوير، من خلال التربية والتكوين والتأهيل، ومستجدات البحث.
لا ينحصر تأهيل الرأسمال البشري في التكوينات المعرفية، الأكاديمية والعلمية والتقنية، بل يشمل أيضا التربية على القيم المختلفة (الثقافية والدينية والسياسية والبيئية …)، في بُعدها المحلي والوطني والعالمي.