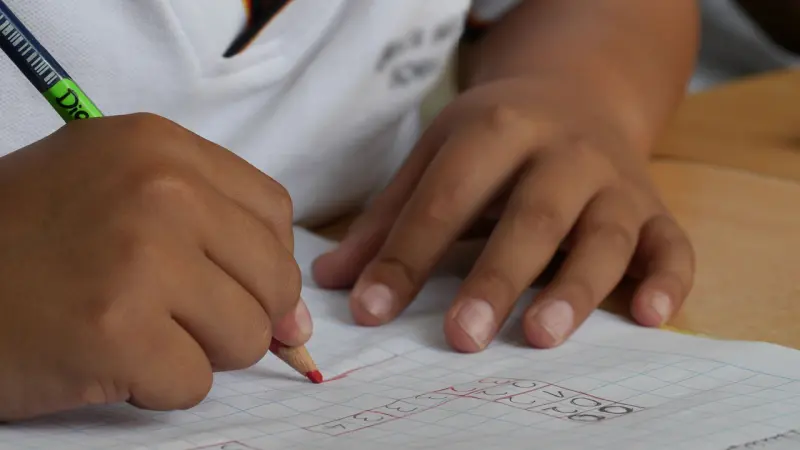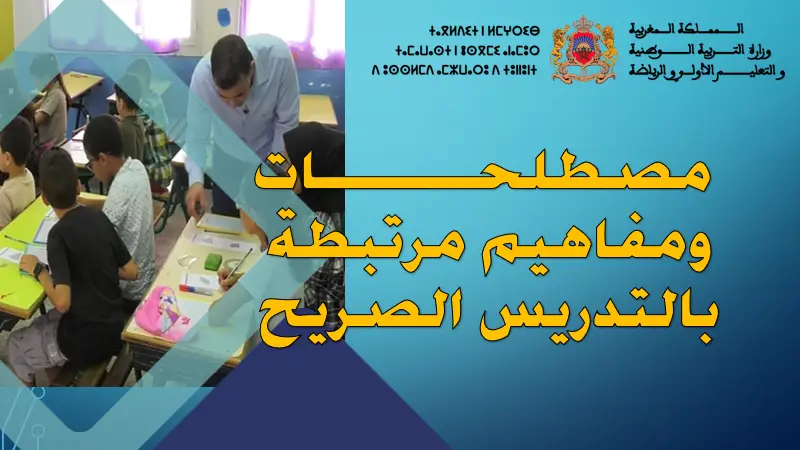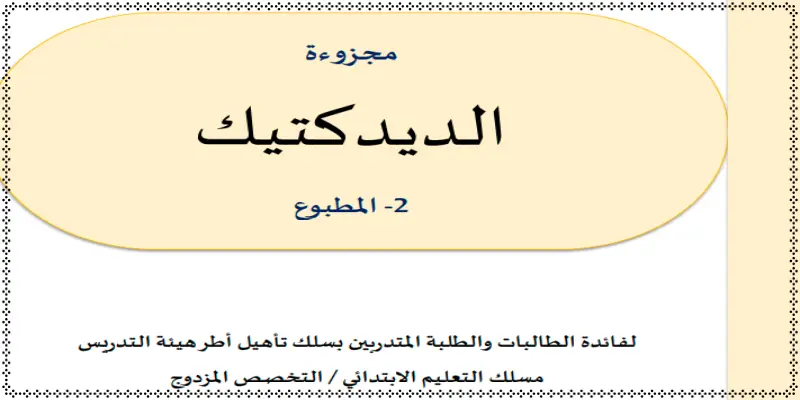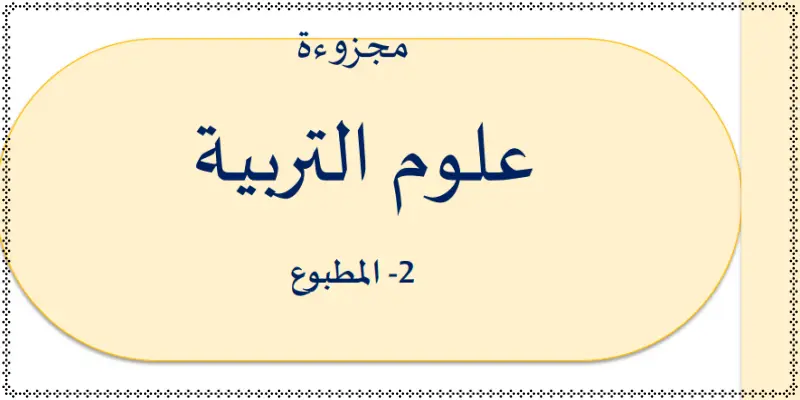تعريف المقاربة
المقاربة (اصطلاحا): هي الكيفية العامة، أو الخطة المستعملة لنشاط ما (مرتبطة بأهداف معينة) والتي يراد منها دراسة وضعية، أو مسألة، أو حل مشكلة، أو بلوغ غاية معينة، أو الانطلاق في مشروع ما؛ وقد استخدمت في هذا السياق كمفهوم تقني للدلالة على التقارب الذي يقع بين مكونات العملية التعليمية التعلمية، التي ترتبط فيما بينها عن طريق علاقة منطقية، لتتآزر فيما بينها من أجل تحقيق غاية تعلمية، وفق استراتيجية تربوية، وبيداغوجية واضحة.
الإطار المفاهيمي
غالبا ما يتم الخلط بين مفهوم الكفاية وبعض المفاهيم القريبة منها، وبالخصوص: المهارة، والأداء، والاستعداد، والقدرة؛ ولإزالة اللبس الحاصل بين هذه المفاهيم ومفهوم الكفاية، سنقوم بتحديد هذه المفاهيم قبل تحديد المفهوم المفتاح (الكفاية).
المهارة
يقصد بالمهارة، التمكن من أداء مهمة محددة بشكل دقيق يتسم بالتناسق والنجاعة والثبات النسبي، ولذلك يتم الحديث عن التمهير (Doron R. et Parot F. 1991)، أي إعداد الفرد لأداء مهام تتسم بدقة متناهية. ومن أمثلة المهارات، ما يلي:
- مهارات التقليد التي تكتسب بواسطة تقنيات المحاكاة والتكرار، ومنها مهارة رسم أشكال هندسية والتعبير الشفوي وإنجاز تجربة…
- مهارات الإتقان والدقة، وأساس بنائها التدريب المتواصل والمحكم.
الأداء
يعتبر الأداء أو الإنجاز ركنا أساسيا لوجود الكفاية. ويقصد به القيام بمهام في شكل أنشطة أو سلوكات آنية ومحددة وقابلة للملاحظة والقياس، وعلى مستوى عال من الدقة والوضوح. (Legendre R., 1988)
الاستعداد
يقصد بالاستعداد مجموعة من الصفات الداخلية التي تجعل الفرد قابلا للاستجابة بطريقة معينة وقصدية، أي أنه مؤهل لأداء معين بناء على مكتسبات سابقة، ومنها القدرة على الإنجاز والمهارة في الأداء. ولذلك يعتبر الاستعداد دافعا للإنجاز لأنه الوجه الخفي له. وتضاف إلى الشروط المعرفية والمهارية شروط أخرى سيكولوجية، فالميل والرغبة أساسان لحدوث الاستعداد.
القدرة
القدرة هي الحالة التي يكون الفرد فيها متمكنا من النجاح في إنجاز معين، كالقدرة على التحليل، والتركيب، والمقارنة، والتوليف…
ويمكن كذلك تعريف القدرة حسب ميريو (Meirieu 1990) بأنها نشاط فكري ثابت قابل للنقل في حقول معرفية مختلفة، فهي مصطلح يستعمل غالبا كمرادف للمعرفة الأدائية savoir faire. فلا توجد أي قدرة في شكلها الخام، ولا تظهر إلا من خلال تطبيقها على محتوى معين.
يستنتج من هذا التعريف أن القدرة لا تظهر إلا من خلال تطبيقها على محتوى أو محتويات متعددة. وكمثال لإبراز قدرة التحليل من خلال تطبيقها على محتويات متعددة، نذكر:
- تحليل جملة.
- تحليل نص أدبي.
- تحليل وضعية-مسألة في الرياضيات.
تقريب مفهوم الكفاية
بالرغم من تعدد تعاريف الكفاية إلا أن لا وجود لاختلاف كبير حول تحديد مفهومها، وحتى وإن وجد اختلاف فإن هناك عددا من الخصائص التي تتفق حولها معظم هذه التعاريف.
تعريف 1
الكفاية هي القدرة على مواجهة وضعيات محددة بالتكيف معها، عن طريق تعبئة وإدماج جملة من المعارف، والمهارات، والتصرفات من أجل تحقيق إنجاز محكم وفعال.
تعريف 2
يعرف “فيليب بيرنو” الكفاية على أنها القدرة على تعبئة مجموعة من الموارد المعرفية لمواجهة فصيلة من الوضعيات بشكل مطابق وفعال.
تعريف 3
الكفاية هي مجموعة من القدرات، والمهارات، والمعارف، والقيم التي يتسلح بها المتعلم لمواجهة مجموعة من الوضعيات، والعوائق، والمشاكل التي تستوجب إيجاد الحلول الناجعة لها بشكل فعال وملائم.
تعريف 4
الكفاية هي القدرة على تكييف التصرف مع الوضعية، ومواجهة الصعوبات غير المنتظرة؛ وكذلك قدرة الحفاظ على الموارد الذاتية للاستفادة منها أكثر ما يمكن، دون هدر للمجهود. إنها القدرة والاستعداد التلقائي بخلاف ما يقابل ذلك من تكرار بالنسبة للآخرين. (Le borterf G., 1995, page 22)
أنواع الكفايات
تصنف الكفايات، بصفة عامة، إلى نوعين أساسيين:
الكفايات النوعية Compétences spécifiques
هي الكفايات التي تنتمي إلى مجال معرفي معين، وتسمى كذلك كفايات خاصة لأنها تخص مادة دراسية معينة.
ومن بين الكفايات النوعية في مادة النشاط العلمي مثلا، نشير إلى:
- تصنيف الأغذية حسب مقاييس معينة.
- تصنيف الطيور باعتماد معايير محددة.
الكفايات الممتدة أو المستعرضة Compétences transversales
هي الكفايات العامة التي لا ترتبط بمجال محدد أو مادة دراسية معينة، وإنما يمتد توظيفها إلى مجالات عدة أو مواد مختلفة.
كفاية امتلاك آليات التفكير العلمي مثلا، هذه الكفاية مستعرضة؛ وذلك لأنها مرتبطة بأكثر من تخصص، إذ أن التفكير العلمي ليس مقتصرا فقط على مادة النشاط العلمي أو الرياضيات، بل يدخل ضمن التخصصات.
ويمكن أن تتخذ الكفايات في المنهاج الدراسي المغربي طابعا استراتيجيا أو منهجيا أو تواصليا أو تكنولوجيا أو ثقافيا، كما هو مبين في الآتي:1
الكفايات الاستراتيجية
تستوجب هذه الكفاية معرفة الذات، والتموقع في الزمان والمكان، والتموقع بالنسبة للآخر وبالنسبة للمؤسسات الاجتماعية والتكيف معها ومع البيئة بصفة عامة، وتعديل المنتظرات والاتجاهات والسلوكات الفردية وفق ما يفرضه تطور المعرفة والعقليات والمجتمع.
الكفايات التواصلية
التي يجب أن تؤدي إلى إتقان اللغة العربية، وتخصيص الحيز المناسب للغة الأمازيغية، والتمكن من اللغات الأجنبية، والتمكن من مختلف أنواع التواصل داخل المؤسسة التعليمية وخارجها، والتمكن من مختلف أنواع الخطاب (الأدبي، العلمي، الفني …).
الكفايات المنهجية
وتستهدف إكساب المتعلم منهجية للتفكير وتطوير مدارجه العقلية، ومنهجية للعمل في الفصل وخارجه، ومنهجية لتنظيم ذاته وشؤونه ووقته وتدبير تكوينه الذاتي ومشاريعه الشخصية.
الكفايات الثقافية
وتشتمل على شق رمزي يرتبط بتنمية الرصيد الثقافي للمتعلم، وشق موسوعي مرتبط بالمعرفة بصفة عامة.
الكفايات التكنولوجية
هي القدرة على إبداع وإنتاج المنتجات التقنية، والتعامل معها وتحليلها، واستدماج أخلاقيات المهن والحرف، والأخلاقيات المرتبطة بالتطور العلمي والتكنولوجي بارتباط مع منظومة القيم الدينية والحضارية، وقيم المواطنة، وقيم حقوق الإنسان ومبادئها الكونية.
مفهوم المقاربة بالكفايات
ظهرت المقاربة بالكفايات في التعليم التقني والمهني لبعض الدول المتقدمة في نهاية السبعينيات من القرن العشرين، وانتقلت تدريجيا إلى التعليم الأساسي ثم إلى باقي الأسلاك التعليمية؛ حيث اعتمدت العديد من الدول السائرة في طريق النمو هذه المقاربة في إطار سياسة إصلاح منظوماتها التربوية منذ بداية هذا القرن. ويرتبط الاهتمام بمقاربة التدريس بالكفايات بالمغرب بالإصلاح الذي عرفته المنظومة التربوية، والذي دخل حيز التنفيذ بداية من الموسم الدراسي 1999/2000 بتطبيق مضمون الميثاق الوطني للتربية والتكوين.
دواعي اختيار مقاربة المنهاج بالكفايات
بناء على ما جاء في الميثاق الوطني للتربية والتكوين المتضمن للفلسفة التربوية، تم تبني المدخل بالكفايات لمراجعة مناهج التربية والتكوين المغربية عوض المدخل بالأهداف الذي كان سائدا من قبل.
ويعتبر هذا التوجه اختيارا بيداغوجيا يرمي إلى الارتقاء بالمتعلم إلى أسمى درجات التربية والتكوين؛ إذ أن المقاربة بالكفايات تستند إلى نظام متكامل من المعارف، والأداءات، والمهارات المنظمة التي تتيح للمتعلم، ضمن وضعية تعليمية، القيام بالإنجازات والأداءات الملائمة التي تتطلبها تلك الوضعية.
وطبيعي أن مقاربة من هذا النوع، تعمل على تركيز الأنشطة على المتعلم، حيث تتمحور كل الأفعال التعليمية التعلمية وما يرتبط بها من أنشطة حوله كفاعل أساسي.
من هذا المنطلق، تبنى عناصر الوضعية التعليمية التعلمية وفق إيجابية المتعلم، حيث تتحد وظائف ومبادئ التعلم في قواعد منها:
- اعتبار المتعلم محورا فاعلا: لأن المتعلم يبني المعرفة ذاتيا (التعلم الذاتي)؛ لذا وجب استحضار سمات شخصيته من قدرات عقلية ومميزات سيكوحركية.
- توفير شروط التعلم الذاتي: وذلك بفتح المجال رحبا لكي يتفاعل المتعلم مع محيطه تفاعلا إيجابيا، قوامه المساءلة والبحث والاستكشاف وفق قواعد التفكير العلمي.
- تمكين المتعلم من كل الشروط والوسائط التي تتيح له هذا التفاعل البناء في ممارسة تعلمه الذاتي: وعلى هذا الأساس، تحتل الطرائق الفعالة (بيداغوجيا حل المشكلات، المشروع …) وتقنيات التنشيط واستراتيجيات التعلم الذاتي مكانا مركزيا في هذا التوجه.
- اعتبار المدرس منشطا وموجها ومسهلا لعمليات التعلم الذاتي: وذلك بما يوفره من شروط سيكو-بيداغوجية وسوسيو-بيداغوجية تتيح التعلم.
ولقد عملت مبادئ بيداغوجيا الأهداف على جعل المتعلم عنصرا سلبيا ومنفعلا، يقبل كل تعليم مبرمج بناء على خطة واختيار لم يكن شريك فيهما، فيخضع لتوقعات المدرس، منفذا لتعليماته، مكتسبا في النهاية تعلما محددا ومشروطا يتميز بخاصيتين:
- خاصية تجزيئية: لأنه عبارة عن سلوكات جزئية وضيقة، عبر عنها بالأهداف الإجرائية.
- خاصية غيرية: لأنه نتيجة لاختيار فاعل خارجي عن ذات المتعلم، وهو المدرس.
واعتبارا لهذه البرمجة وهذه الاختيارات وغيرها، جاءت الانتقادات الموجهة إلى بيداغوجيا الأهداف عنيفة، حتى من السلوكيين أنفسهم، كما هو الأمر عند بوفام وإزنر وكانييه. وقد أثار هذا الأخير الاهتمام بفاعلية الشروط الداخلية للمتعلم واعتبرها أمرا ضروريا لحدوث التعلم. كما عمل من جهة أخرى على تجاوز المفهوم الضيق للسلوك (الهدف الإجرائي) إلى مفهوم أوسع هو القدرة؛ وذلك لأن الهدف الإجرائي إنجاز جزئي مرتبط بنشاط محدد ومعين، في حين أن القدرة، حسب مفهوم كانييه، تشمل إنجازات متعددة ومترابطة فيما بينها بقواسم مشتركة.
وعلى هذا الأساس جاء مدخل الكفايات، اختيارا تربويا استراتيجيا، ليجعل من المدرس فاعلا يعمل على المساهمة في تكوين القدرات والمهارات، ولا يبقى منحصرا في مد المتعلم بالمعارف والسلوكات الجزئية.
خلاصة
بالتالي يتضح أن المقاربة بالكفايات:
- تفسح الفضاء المدرسي وتجعله يشجع على التعلم الذاتي.
- تجعل المتعلم في قلب العملية التعليمية التعلمية.
- تربط التعلم باهتمامات المتعلمين.
- تيسر النجاح في توظيف التعلمات لحل المشكلات، وذلك بما تحققه من كفايات عبر مختلف المواد والوحدات التعليمية.
- تعطي للتعلمات المكتسبة، في فضاء المدرسة، دلالات حقيقية.
- مديرية المناهج شتنبر 2011، البرامج والتوجيهات التربوية الخاصة بسلك التعليم الابتدائي، الصفحة 10 ↩︎